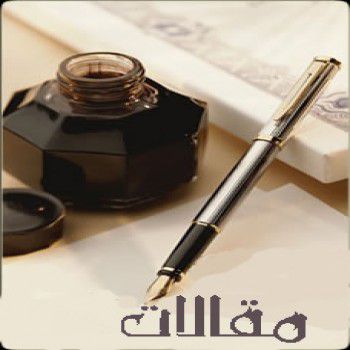الدكتور علي المؤمن ومشروعه الفكري لتأسيس علم اجتماع ديني شيعي
بقلم //أحمد رجب شلتوت
يمثل المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن نموذجاً مثالياً للباحث والمفكر المسلم المشغول بقضايا أمته، والذي يسخِّر معارفه وجهوده البحثية لمعالجة تلك القضايا؛ فأصبحت دراسة هذه القضايا نفسها هي مشروعه الفكري الذي أوقف كل جهوده عليه، وقد أثمرت جهوده أكثر من خمسة وعشرين مؤلفاً، تكشف ـــ ابتداء من عناوينها ـــ عن اشتغالاته الفكرية.و
الدكتور علي المؤمن رغم انتمائه الشيعي وانشغاله بهاجس الهوية الشيعية، خصوصاً العراقية، ومحاولاته لرصد ملامحها وحدودها وتفاعلاتها مع الهويات الأخرى؛ إلا أنه ينطلق في ذلك من هم إسلامي عام، فمثلاً في كتابه “من المذهبية إلى الطائفية: المسألة الطائفية في الواقع الإسلامي” يدرس المسألة الطائفية، كواقع موضوعي تراكمي في حياة المسلمين، تدخّلت عدة عوامل في صنعه وإنتاجه، ابتداءً من نشوئه كنتيجة للخلاف على موقع قيادة الأمة، ويتابع تبلوره مذهبياً فيما بعد، وصولاً إلى تحوله إلى صراع طائفي سياسي. وهنا يقف الدكتور المؤمن من خلال دراسته للطائفية، على عمق المخاطر الناتجة عن هذا الواقع، وهي المخاطر التي تحدق بالجميع، وهو بذلك يستهدف الوصول إلى قناعة مشتركة بين حكماء الأمة من السنة والشيعة، تعمل على تجسير الفجوة بين طائفتيهما؛ لذلك يضع وبحسب عنوان كتاب آخر له “الغزو الطائفي في مواجهة المشروع الحضاري الإسلامي”؛ فقناعته الثابتة أن الطائفية خطر داهم يهدد مستقبل الأمة ويعوق نمو مشروعها الحضاري.
هكذا ينطلق الدكتور علي المؤمن من قضايا الطائفة التي ينتمي إليها “الشيعة” إلى قضايا الأمة الإسلامية بأسرها؛ فهو في بحثه عن خصوصيات الطائفة، يؤكد على القواسم المشتركة بين كافة طوائف الأمة، كذلك فهو حينما ينشغل بالماضي، كما في كتبه عن “ثقافة عاشوراء”، و”مسيرة الحركة الإسلامية في العراق”، و”القرن العشرون: مائة عام من العنف”، لا نجده ماضويا في تفكيره وفي توجهاته، بل نجده من خلال دراساته للتاريخ، يسهم في تمهيد سبيل فكري نحو المستقبل، كما نجد في كتبه “أسلمة المستقبل: نحو الإمساك بالمستقبل الإسلامي”، و”المستقبلية الإسلامية: منهجية علمية لبناء غد أفضل”، و “من المعاصرة إلى المستقبلية: الفكر الإسلامي واستدعاءات المستقبل”.
هكذا تكشف عناوين كتب الدكتور علي المؤمن عن جوهر مشروعه الفكري الذي ينطلق من الخاص (الشيعي) ليلامس قضايا العام (الإسلامي)، وقد استطاع أن يرصد التشيع كظاهرة اجتماعية أو مكون اجتماعي له خصوصيته وتطلعاته، وأيضا مشاكله وإخفاقاته، وقد وُفق في الوقوف على ما تمتاز به الكتلة البشرية الشيعية، بعيداً عن الجانب العقدي أو الديني، أي أنه يهتم بالمكون الشيعي بكله الديني واللاديني؛ فمهمته رصد الخصائص الاجتماعية التي تميزه عن سواه. وهذا ما نجده في كتابه المميز “الاجتماع الديني الشيعي: ثوابت التأسيس ومتغيرات الواقع”؛ فهو حينما تطرق إلى الأصول التي يرتكز عليها المجتمع الشيعي، لم يقف عند حدود أصوله العقدية وقواعده الفقهية؛ وإنما تجاوزها ليلامس نوعیة المجتمع الإنساني ومساراته التاريخية، كاشفاً عن هوية ومكونات ذلك المجتمع، وقواعده النظرية، وتراكماته التاريخية التي يستند إليها النظام الاجتماعي الديني الشيعي.
المنهج والمسار
يمكن تعريف “علم الاجتماع الديني” على أنه العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية في ميدان الدين والعلاقات الاجتماعية للدين في الداخل والخارج؛ فهو يتناول دراسة الكيانات والعمليات الاجتماعية التي تنتمي لميدان الظواهر الدينية، ويهدف إلى تحليل أبنيتها والقوانين التي تخضع لها. ويرى كل من “سابينو اكوافيفا” و”بيس انزو” في كتابهما المشترك “علم الاجتماع الديني: الإشكالات والسياقات”، أن علم الاجتماع اهتم منذ ظهوره بالدين: معناه، ووظائفه في المجتمع، ويؤكدان أن مهمته ليست اختراع ظواهر الاجتماع الديني أو اختلاقها، ولا الاستدلال على صحتها وخطئها؛ لأنه ليس علماً تجريبياً ومعيارياً، ولا علاقة له بالسجال الديني والمذهبي؛ بل هو أداة لدراسة ظاهرة قائمة. وبالتالي؛ يتعامل الباحث مع علم الاجتماع الديني باعتباره أداة معرفية لاكتشاف معالم الظاهرة الاجتماعية الدينية، وتوصيفها وتحليلها، وترسيم هيكليتها وأنساقها المعرفية والعملية، وعلاقاتها الداخلية والخارجية، ومقارنتها بالظواهر الأُخر المشابهة أو المتعارضة.
هذا ويمثل علم الاجتماع الديني التقليدي الفهم السوسيولوجي العلماني للدين، في مواجهة الفهم الكنسي للدين، الذي يدرس الدين من داخله، أي من خلال العقيدة والفقه وعلوم النص المقدس، بينما علم الاجتماع الديني، يدرس الدين من خارجه، وبعيداً عن حضور المقدس والتقاليد الدينية النصوصية. وهو ما يسميه الدكتور علي المؤمن بالنظام الاجتماعي الديني، وبالطبع فإن كتابه يتناول “النظام الاجتماعي الديني الشيعي”، باعتباره ظاهرة مركبة، دينية اجتماعية تاريخية إنسانية، تستند إلى قواعد تأسيسية نظرية، عقدية وفقهية وتاريخية، وتقف على بنى اجتماعية دينية، واجتماعية سياسية، واجتماعية ثقافية، واجتماعية معرفية. وتمثل هذه القواعد النظرية الدينية والبنى الاجتماعية الناشئة عنها، تمثل المداخل العلمية الأساس الكاشفة عن معالم النظام الديني الاجتماعي الشيعي. ومن أجل دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية المركبة، لا بدّ من وجود أدوات منهجية معرفية تحتوي على أنساق وقوالب ومعادلات، تعمل على توصيف الظاهرة وتحليلها واكتشاف معالمها.
ونظرية الدكتور المؤمن لا تعنى بدراسة التشيع كمذهب ديني عقدي فقهي، وبالتالي؛ فإنه لا يتناول السجال الديني المذهبي في أبعاده العقدية والفقهية أو السجال التاريخي العلمي؛ بل يعمل على مقاربة تأثيرات هذه السجالات إنسانياً واجتماعياً وتنظيمياً وثقافياً وسياسياً؛ فهو معني بالمجتمع الإنساني الذي أفرزه التشيع في مرحلة غيبة الإمام المهدي، وليس في مرحلة حضور المعصوم، أي ليس بالتشيع فقهاً وعقيدة. كما أنه لا يقصد بالنظام الاجتماعي الديني الشيعي مفهوم المرجعية الدينية الشيعية؛ بل يقصد به ((النظام الجامع الذي تقف المرجعية الدينية على رأسه))؛ فالمرجعية تقود النظام ولا تتلخص فيه، في حين تشكل باقي المكونات أجهزة هذا النظام وقواعده البشرية.
ويرى الدكتور علي المؤمن أن مصطلح «النظام الاجتماعي الديني الشيعي» مصطلح جامع يستوعب كل جوانب الكيانية الشيعية في بعديها النظري والعملي، يقارب حقيقة هذه الكيانية الاجتماعية الدينية الثقافية السياسية التي تعبر عن واقع الشيعة الإمامية الاثني عشرية ومسارهم التاريخي والجغرافي، بوصفهم أكبر جماعة بشرية منظمة في العالم، وتنتمي إلى مدرسة إسلامية تتميز عن غيرها من المدارس الإسلامية المنتسبة إلى فقهاء مدرسة الخلفاء والصحابة في فهمها للدين الإسلامي وعقيدته وفروعه، وهو فهم يستند إلى أئمة آل البيت حصراً، وكذلك في قراءتها للتاريخ الإسلامي، وفي نفيها لشرعية الأنظمة السياسية التي لا تستمد شرعيتها من أصل الإمامة المنصوص عليها.
أما عن دوافع الدكتور علي المؤمن لتأسيس علم الاجتماع الديني الشيعي؛ فهي تتمثل في احتياج “النظام الاجتماعي الديني الشيعي” لدراسة علمية معمقة؛ بوصفه أهم ظاهرة اجتماعية دينية سياسية في العالم على الإطلاق، خاصة مع عدم قدرة مناهج علم الاجتماع الديني الوضعي على دراسة الظاهرة الدينية الاجتماعية الشيعية دراسة موضوعية تكشف عن حقائق الظاهرة وبناها المركبة.
ستة عصور للشيعة
يعتمد الباحث منهجاً تاريخياً وصفياً تحليلياً في تقسيم تاريخ النظام الاجتماعي الشيعي؛ فهو يقسمه إلى ستة عصور أساسية متتابعة، لكل منها مؤسس وقائد تاريخي، ويعقبه أفول تدريجي، وعلى الرغم من ارتباط هذه العصور بشخصيات ذات قداسة دينية، إلّا أن الدكتور المؤمن يؤكد على عنايته بالأدوار الواقعية للشخصيات، وما قاموا به، وليس شخصياتهم وقداستهم، فقد كان معنياً ((بالبعد الواقعي الحسي وليس البعد المعنوي الروحي))، أي أن هذه العصور ليست سياسية أو فقهية، بل هي عصور شاملة لصعود النظام الاجتماعي الشيعي، واستحكام دعائمه وقواه الميدانية.
ويؤرخ الكاتب لنشوء النظام الاجتماعي الديني الشيعي بالعام 632 ميلادية، وهو العام الهجري الحادي عشر، في عصر إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد نشأت قواعده على مبدأ «الإمامة»، والحدث المفصلي الذي أدى إلى ولادة هذا العصر يتمثل في إبعاد الإمام عن إمامة الأمة.
وقد استمر هذا العصر لمدة 112 عاما، وفي عام 132 ه، بدأ العصر الثاني على يد الإمام جعفر بن محمد الصادق، وذلك إثر سقوط الكوفة في يد العباسيين وانهيار الدولة الأموية، وشهد هذا العصر تبلور المدرسة الفقهية الشيعية، وقد استمر هذا العصر 128 عاما تقريبا، وشهد هذا العصر إمامة موسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري ومحمد المهدي المنتظر. وقد بدأت بوادر أفوله حينما شددت الدولة العباسية قبضتها على الشيعة؛ فتراجع نظامها الاجتماعي تدريجياً، حتى انتهى العصر الثاني بغيبة الإمام المهدي وظهور زعامة نائبه الخاص الأول الشيخ عثمان بن سعيد العمري في بغداد في العام 260هـ (874م)، حيث بدأ العصر الثالث. وإذا كان الإمام علي بن أبي طالب هو مؤسس النظام الاجتماعي الديني الشيعي في عصر الإمامة؛ فإنّ الشيخ العمري هو مؤسس النظام الاجتماعي الديني الشيعي في عصر الغيبة، خاصة أن هذا العصر شهد بداية الغيبة الكبرى، وتأسيس الحوزة العلمية في قم، وهو يمثل أحد العصور الذهبية للشيعة؛ إذ تخلله سيطرة الحكومات الشيعية على أغلب العالم الإسلامي، لكن هذا العصر الذهبي انهار برمته على يد صلاح الدين الأيوبي.
أما العصر الرابع فقد بدأ مع هجرة الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف الأشرف وتأسيس حوزته العلمية في العام 448هـ (1056م)، وتميز باستحكام الدعائم الفكرية والعملية للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، وهيكليته وامتداداته في الجوار الإقليمي؛ إذ أسس الشيخ الطوسي للمركزية في النظام الاجتماعي الديني الشيعي، كما كان في عصر الأئمة الاثني عشر؛ فالنجف لم تكن مجرد حوزة علمية أو حاضرة دينية، بل تحولت ولأول مرة إلى عاصمة مركزية للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، كونها مدينة شيعية خالصة، وهو ما لم يكن متحققاً في بغداد. وقد استمر هذا العصر ما يقرب من (459) سنة، أي حتى ظهور الدولة الصفوية في العام 907هـ (1501م) على يد الشاه إسماعيل الصفوي، وحينها بدأ العصر الشيعي الخامس مع تأسيس أول دولة شيعية إقليمية، منذ انهيار الدولة الفاطمية قبل ذلك التاريخ بثلاثة قرون ونصف، وكان البناء المذهبي للدولة الصفوية يقوم على جهود الفقهاء العرب، ولذلك؛ فإنّ المنظومة العقدية والفقهية التي حكمت الدولة الصفوية؛ أنتجها علماء دين عرب، وليسوا فرساً. وقد استمر الصعود الشيعي السياسي والثقافي والاجتماعي لمدة (262) سنة، أي حتى انهيار الدولة الصفوية في العام 1763م.
أما العصر السادس فقد تأخر حتى نجاح الثورة الإيرانية، وتأسيس الدولة الإسلامية الشيعية في إيران في العام 1979م؛ ليصبح الإمام الخميني ثاني مرجع ديني في التاريخ يؤسس لعصر شيعي بعد الشيخ الطوسي. وتختلف الدولة التي أسسها الإمام الخميني في أنها هي أول دولة شيعية عقدية في عصر الغيبة، تستند إلى مبدأ ولاية الفقيه، وأول حكومة إسلامية عقدية إمامية بعد حكومة الإمام الحسن بن علي. وقد انتشرت آثار هذا العصر الذهبي ليشمل جميع دول الحضور الشيعي، فضلاً عن بلدان الإسلامية والعالمية الأُخر.