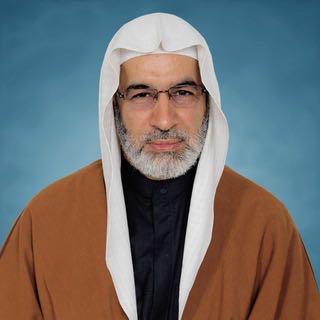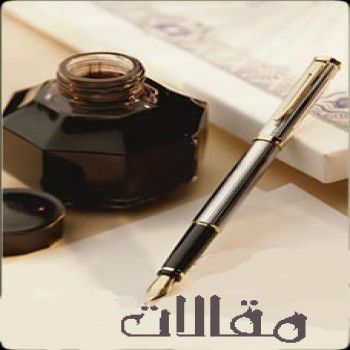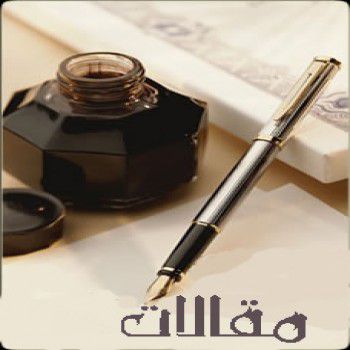[ وقفة موجزة مع ( الخطبة الشِّقشِقيّة ) في حلقات ] ( 2 )
بقلم //حسن عطوان
الحلقة الثانية :
6. ( فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذًى وَفِي الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِي نَهْباً ) .
– ( هَاتَا ) هذه .
– ( أَحْجَى ) : من الحجا بمعنى العقل ، أي أنّه ( عليه السلام ) رأى أنَّ الصبر على هذه الطَخْيَةٍ العَمْيَاءَ أحجى ، أي أقرب إلى العقل وأولى من الصولة بلا نصير .
– ( قَذًى ) : القذى ما يصيب العين من تراب ونحوه .
– ( شَجًا ) : الشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه .
– ( تُرَاثِي ) : التراث أي الميراث .
ويقصد الإمام به هنا : ما أوصى له به النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلَّم ) من قيادة الأمّة بعده في الدين والدنيا .
– ( نَهْباً ) : مغتصباً منهوبا .
– فصبر عليه السلام على طول المدة ، وهو يتحمل الأذى كالذي في عينه القذى وفي حلقه الشجى ، فصار جليس بيته ، وحُرمتْ الأمّة من علمه وعطاءه .
7. ( حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ )
– ( فَأَدْلَى ) : أدلى الدلو : ألقى به في البئر .
– ثم أنَّ أبا بكر لما دنت منه المنية ألقى بها ، أي أوصى بها الى عمر .
8. – ثُمَّ تَمَثَّلَ [ الإمام ] بِقَوْلِ الْأَعْشَى – :
( شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا * وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ ) :
– ( كُورِهَا ) : الكور : الرحل ، والضمير راجع إلى الناقة المذكورة في الأبيات التي تسبق هذا البيت .
– وحيان كان سيداً في قومه مطاعاً فيهم ، وله حظوة عند ملوك فارس ، وفي نعمة واسعة ، وكان الأعشى ينادمه ، والأعشى هذا هو الأعشى الكبير ، أعشى قيس وهو أبو بصير ميمون بن قيس ، وجابر أخو حيان الأصغر .
– والأعشى في هذا البيت يقول :
إنَّ فرقاً كبيراً بين يومه في سفره وهو على كور ناقته ، وبين يوم حيان في رفاهيته ، فإنَّ الأول كثير العناء شديد الشقاء ، والثاني وافر النعيم والراحة .
وأمير المؤمنين استشهد بذلك ليقول :
شتان بين يومي في الخلافة مع إنحراف أسس له السابقون ، وإضطراب كبير ترتب على سلوكياتهم ، وبين خلافة عمر التي أُدليَ له بها والأمور ممهَّدَة .
أو : أنّه أراد أنْ يبيّن الفرق بين حالته في زمن النبي الأكرم ، وما كان فيه من تكريم الرسول وإجلال الصحابة له ، وبين حالته بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) وما لحق به من المحن و المصائب .
9. ( فَيَا عَجَباً بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا )
– ( يَسْتَقِيلُهَا ) : يدّعي أنّه لا يريدها .
( تَشَطَّرَا ) : أي أخذ كل منهما شطراً .
( ضَرْعَيْهَا ) : الضرع هو في الحيوانات مثل الثدي للمرأة .
– أي إقتسما فائدتها ونفعها ، والضمير يعود للخلافة .
– يتعجب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هنا من أبي بكر حيث كان يطلب إقالته من الخلافة ، و يقول : ( اقيلوني ، فلست بخيركم ) ، فمَن نفى عن نفسه الصلاحية للخلافة كيف يجوز له أنْ يعهد بها إلى غيره ؟؟
– ( لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا ) : شبّه عليه السلام الخلافة بالناقة التي تُحْلَب ، وأنَّ الرجلين تقاسما الخلافة بينهما .
– نقل المؤرخون : إنَّ أبا بكر حينما كان يتقلب على فراش الموت ويجود بنفسه ، ويغمى عليه ساعة ، وينتبه أخرى ، أمر بإحضار عثمان بن عفان ، فحضر فأمره أنْ يكتب عهداً ، وقال : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم
هذا ما عهد به عبد الله بن عثمان [ عثمان : إسم أبي قحافة ] الى المسلمين ، ثم أغُمي عليه .
فكتب عثمان : قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب .
ولمّا أفاق ابو بكر قال : إقرء عليّ ما كتبت فقرأ ، فكبّر ابو بكر وسرّ .
وقال : أراك خفت أنْ يختلف الناس إنْ مت في غشيتي ؟
قال : نعم .
قال : جزاك اللّه خيراً عن الاسلام وأهله .
ثم أتم العهد ، وأمر أنْ يُقرأ على الناس ، فقُريء عليهم .
ثم أوصى عمر بأمور ..
[ إبن أبي الحديد ، عبد الحميد بن هبة الله ، ( ت : 656 هج ) ، ( معتزلي ) ، نهج البلاغة ، ج 1 ، ص 165 ، دار إحياء الكتب العربية ]
– وكان عمر يومئذ حاضراً عنده ، وعلم بالوصية ، ولكنّه لم يقل : إنَّ الرجل ليهجر ، أو : أنّه قد غلب عليه الوجع ، حسبنا كتاب اللّه !!
10. ( فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا [ في نسخة : كَلامُهُا ] وَيَخْشُنُ مَسُّهَا وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَالِاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ )
– ( حَوْزَةٍ ) : ناحية وجهة أو طبيعة .
– ( كَلْمُهَا أو كَلامُهُا ) : الكَلْم هو الجرح ، والمعنى : أنَّ خشونة تلك الجهة أو الطبيعة تودي الى جروح شديدة .
وإذا كانت الكلمة ( كَلامُهُا ) : فالمراد من غلظة الكلام : خشونته .
– ( الصَّعْبَةِ ) : الصعبة من الإبل ما ليست منقادة لراكبها .
– ( أَشْنَقَ ) : أشنق البعير وشنقه : كفه بزمامه .
– ( خَرَمَ ) : شق أنفها .
– ( أَسْلَسَ ) : أرخى .
– ( تَقَحَّمَ ) : رمى بنفسه في القحمة أي الهلكة .
والمعنى : إنَّ أبا بكر قد جعل الخلافة في ناحية وجهة أو طبيعة خشناء .
والمقصود من تلك الناحية عمر ، أو طبيعته وأخلاقه ، إذ كان فظاً غليظاً صعباً ، يتسرع الى الغضب ، وكلامه كان خشناً حتى مع رسول الله ، كالذي جرى منه في صلح الحديبية ، وكالذي قاله في حضرة الرسول في يوم وفاته ، حينما طلب ( صلى الله عليه وآله وسلَّم ) دواة وقلم ، ليكتب لهم وصية لا يختلفون بعدها في شيء .
– ( وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَالِاعْتِذَارُ مِنْهَ )
يشير الإمام بذلك إلى نتائج تلك الطبيعة والأخلاق الخشنة ، حيث كانت لعمر عثرات في فتاواه وقضاياه ،جرّاء إسلوبه الخشن وتسرعه في الحكم من غير علم .
فعمر كان كثيراً ما يحكم بالامر ثم ينقضه ، ويفتي بالفتيا ثم يرجع عنها ، ويعتذر مما أفتى به أولاً .
والضمير في ( فيها ) يعود إلى الحوزة الخشناء ، فيكون المعنى : إنَّ مَن يصاحب عمر كراكب الناقة الصعبة التي لا تنقاد ، اي أنَّ الذي يرافقه ويصاحبه واقع بين المحذورين : إنْ أشنق له خرم وإنْ أسلس له تقحم .
أي إنْ منعه عن أفعاله وفتاواه فسيؤدي ذلك إلى نزاع وخلاف ، وإنْ تركه بحاله ألقى نفسه وغيره في المهلكة ، تماماً كالناقة الصعبة إنْ أشنق لها راكبها ، وجرَّ زمامها جرّاً قوياً ينشق أنفها ، لإرتباط الزمام بالأنف ، وإنْ أرخاه ألقته في المهالك ، كسيارة عطلت آلة توقيفها ، فإنّه إذا كثر عليه الإنكار من الناس لخشونة أخلاقه وتسرعه في الحكم أدى ذلك الى فساد الحال بينه وبين الناس ، وإذا تركه الناس ولم يعترضوا عليه أدّى ذلك الى إختلال النظام ، وقتل الأبرياء ، والحكم بغير ما أنزل الله سبحانه .
*************
[ له تتمّة إنْ شاء الله ]
عظّم الله أجوركم .