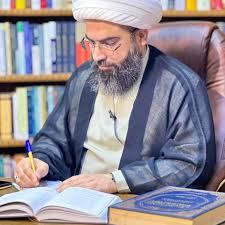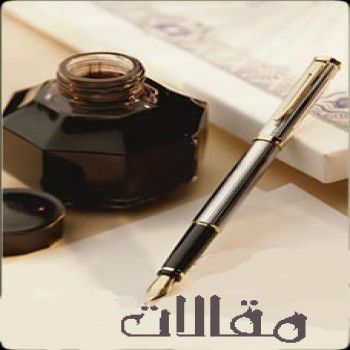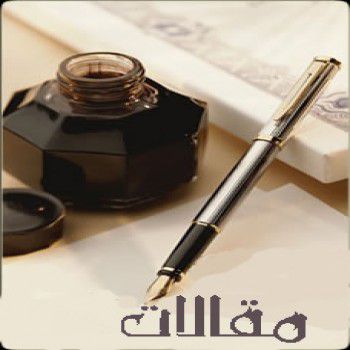هكذا فهمتم (٣)
محمد باقر الصدر: المعادلة الصعبة بين العقل والنص والثورة
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم _الشيخ مجيد العقابي
هل ترى السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره (1935–1980) فقيهًا تقليديًا في حوزة علمية تعج بالمراجع وحملة العمائم، ام كان مشروعًا حضاريًا متكاملًا اختصر في عمره القصير ما لا تختصره أعمار من التنظير والانكفاء!.
فقد تشكل وعيه مبكرًا بين أروقة النجف العلمية، لكنه لم يسمح لتلك الأروقة أن تغلق عليه نوافذ العالم. بل خرج منها إلى الناس، إلى الفقراء، إلى التلاميذ، إلى البسطاء، إلى السياسيين، وإلى الحالمين. فكان صوتًا للفكرة، وشهيدًا للموقف، ومنبرًا لتجديد لا تصنعه الصراخات ولا تحفظه الحشود، بل تصنعه القدرة على أن تزن النص بالعقل، والعقل بالوحي، والوحي بالواقع، والواقع بالمآل.
الصدر رجل بدأت ملامح نبوغه من الطفولة؛ يتيمًا، لكنه حادّ الذكاء، سريع الحفظ، عميق التفكير. وحين وصل إلى النجف لم يكن تلميذًا كسائر التلاميذ، بل صار أستاذًا ومجددًا وهو في العقد الثاني من عمره. كتب “فلسفتنا” ليرد على الماركسية في ذروتها، و”اقتصادنا” ليؤسس مذهبًا اقتصاديًا لم تكتبه قبله حوزة ولا جامعة.
أما في علم الأصول فصاغ الحلقات الثلاث التي أزاحت جبال الغموض عن أصول الفقه وجعلت له بنية ممنهجة لم تعرفها كتب الحلقات القديمة. لكنه، مع ذلك، لم يكن منغلقًا في أفق الفقيه الصرف، بل كان فيلسوفًا، أصوليًا، مصلحًا، ومجددًا حاول أن يعيد للمجتمع الإسلامي معناه الرسالي الغائب.
في كتابه “فلسفتنا” صاغ الصدر نقدًا مزدوجًا للرأسمالية والماركسية، حيث وجد في الأولى عبودية السوق، وفي الثانية عبودية الدولة. ورأى أن الإنسان في كلا النموذجين مجرد ترس في آلة أكبر منه: في الرأسمالية ترس إنتاج واستهلاك بلا غاية، وفي الماركسية ترس في طبقة تقاتل طبقة باسم التاريخ، دون روح أو عمق. رفض فكرة الصدفة، وفكرة المادة الأولى، واعتبر أن الدين ليس “أفيونًا” كما رآه ماركس، بل حاجة وجودية للإنسان الباحث عن القيمة. لكن الصدر لم يقع في فخ الوعظ، بل أسس في كتابه “فلسفتنا” منهجًا فلسفيًا جديدًا يواجه المادية الجدلية والوجودية بالأصول الكلامية الإسلامية، ويعيد تعريف المعرفة من خلال علاقتها بالمطلق الإلهي لا بالحواس فقط. وقد وضع في هذا الكتاب لبنة لنمط جديد من الإنتاج الفكري، لا يكرر فيه مقولات الغزالي وابن رشد، ولا ينسخ فوكو وسارتر، بل يقدّم نصًا ذا هوية، يفكر بالعربية، ويحاور العالم.
ولقد قرأت الكتاب في اوائل العقد الثاني من عمري أواخر الثمانينيات وهو كتاب ممنوع طبعا ففهمت ماهو الفرق بين المذاهب الفكرية والاقتصادية واستغربت ان السيد قدس سره انصف الشيوعية بالمقارنة باخواتها الثلاث ثم فندها بقوة المنطق لا منطق القوة.
أما كتابه “اقتصادنا”، فهو أكبر من مجرد ردّ على ماركس، بل هو محاولة لصياغة نظرية اقتصادية إسلامية متكاملة تتجاوز الرأسمالية والاشتراكية، ولا تكتفي بطرح الحلال والحرام، بل تقدم منطلقات وأهداف ونظم توزيع وملكية، قائمة على مبدأ “خلافة الإنسان عن الله في الأرض” و”المال مال الله” و”العدالة الاجتماعية واجب شرعي”. وابتكر الصدر مفهوم “منطقة الفراغ” ليؤسس لمنطقة تشريعية مرنة في الدولة الإسلامية، يمكن فيها للحاكم العادل أن يسد الحاجة بالتشريع دون أن يخرج عن الإسلام. وفي هذا مزج نادر بين النص والاجتهاد والسياسة، بين الثابت والمتغير، بين النص المقدس وحاجات الدولة الحديثة. ورغم أن بعض الاقتصاديين رأوا أن “اقتصادنا” يفتقر للغة الأرقام والبيانات المعاصرة، إلا أن الصدر لم يكن يكتب كتابًا محاسبيًا، بل يضع أساسًا لمذهب اقتصادي له روحه ومقاصده ومصادره الخاصة.
في الفقه، لم يكتف الصدر بالتقليد، بل جدد في المنهج، وكتب “الفتاوى الواضحة” بعبارات يفهمها عامة الناس، وهو ما عدّه بعض المحافظين تبسيطًا مخلًا، وعدّه آخرون إصلاحًا ضروريًا. وكتب مقدمة عقائدية لهذا الكتاب كانت بذاتها دروسًا في التوحيد والنبوة والمعاد. وفي الأصول، وضع “الحلقات الثلاث”، والتي صارت مناهج حوزوية معتمدة، تنقل الطالب من البسيط إلى المركّب بأسلوب تربوي تدريجي لم يعرفه علم الأصول من قبل. وقد أدخل مفاهيم جديدة إلى علم الأصول كالحق الطولي وحق الطاعة والتوالد الذاتي للأحكام، مما جعله لا مجرد شارح، بل مؤسسًا.
لكن السيد الصدر لم يكن مفكرًا في الكتب فقط، بل كان صاحب رؤية في الدولة والمجتمع. طرح نظرية “خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء”، ليضع إطارًا للنظام السياسي الإسلامي في عصر الغيبة، حيث الأمة هي الخليفة، والعلماء هم الشهداء على المسيرة. وبهذا، قدم نظرية سياسية تجمع بين سلطة الأمة وروح الشريعة، لا تنسخ الديمقراطية الغربية، ولا تكرر ولاية الفقيه المطلقة كما عرفتها مدرسة قم، بل تطرح بديلًا متوازنًا فيه للشعب كلمته وللفقيه إشرافه، وللشريعة حضورها. رفض الدكتاتورية، رفض الحزب الواحد، ودعا إلى مؤسسات منتخبة ودولة قائمة على القيم. وفي انتفاضة رجب 1979 وجّه بيانه الشهير إلى الأمة العراقية داعيًا إلى الحرية، فكان آخر بياناته وآخر صرخاته قبل أن يسلمه البعثيون إلى مقصلة الشهادة.
وربما كان أجمل ما في الصدر أنه كان واعيًا بأزمة المرجعية. ففي أطروحته “المرجعية الصالحة” دعا إلى مرجعية مؤسساتية لا فردية، تُدار بلجان متخصصة، وتعمل على ملفات المجتمع لا على بريد الاستفتاء فقط. كان يرى أن المرجعية ينبغي أن تكون قائدة لا راكدة، مبادرة لا متأخرة، وأنها ينبغي أن تخضع لهيكل تنظيمي لا لعلاقات شخصية. وهذا الطرح – رغم جودته – لم يجد فرصته الكافية، لا بسبب الرفض العلني بل بسبب الموت المبكر الذي حال دون إكمال المشروع.
ما يُحسب له أنه أسس لـ”إسلام حي”، يخاطب العقل والوجدان، ويمتد من الحوزة إلى الجماهير. وما يُؤخذ عليه أن مشروعه ظل نظريًا في كثير من وجوهه؛ لم يكتمل تطبيقه في أي تجربة حكم، ولا في نظام اقتصادي، ولا في إدارة مرجعية. لكن تلك ليست مسؤوليته وحده، بل مسؤولية أمة خذلته حيًا، ونحت صورته شهيدًا.
الذين عرفوه عن قرب قالوا إنه كان خجولًا، حيِّيًا، رقيق الصوت، قوي الحجة، إذا قرأ أبكى، وإذا تكلم أقنع، وإذا كتب علّم. لم تكن قسوته في صوته بل في منطقه، ولم تكن ثورته في سلاحه بل في فكره. خرج من بين جدران مدرسة النجف ليكون مدرسة بحد ذاتها، قرأ الغرب ولم يُغرق فيه، فهم التراث ولم يُدفن تحته، أراد أن يكون الإسلام منهجًا واقعيًا للحياة، لا مجرد طقوس في المساجد.
استشهد الصدر بعد أن كتب للجيل كلمات لا تموت: “إنني صممت على الشهادة، ولعل هذا آخر ما أكتبه لكم”. لم يكن مهووسًا بالموت، بل كان يرى أن الشهادة ضرورة حين تخنقك الحياة، فاختارها وهو يعلم أن صدام لا يترك صوتًا حرًا يعيش. لكن الصدر لم يمت، بل تحوّل إلى ذاكرة أمة، إلى رمز للفكر النظيف، والسياسة النظيفة، والمرجعية المجددة، والعقل الممزوج بالحب والخوف على المصير.
محمد باقر الصدر، كما فهمته، كان عقلًا كبيرًا في جسد نحيل، لكنّه لم يكن وحيدًا، فقد آمن أن الأفكار لا تموت ما دامت صادقة، وأن الدم حين يُسكب على الورق يصير حبرًا، وحين يُسكب على الأرض يصير طريقًا. وقد كان دمه طريقًا سلكته أجيال من المجددين، لكنه لم يُعوّض بعد.
الشيخ مجيد العقابي
مركز الفكر للحوار والإصلاح