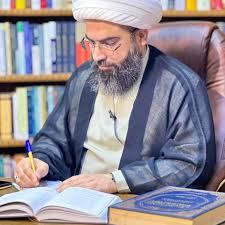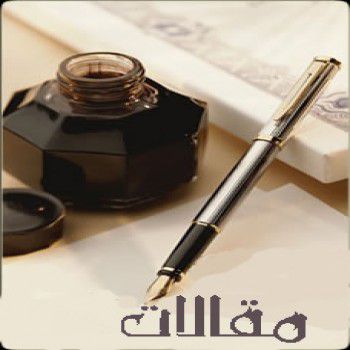هكذا فهمتم (٤)
حسن حنفي: المفكر الذي أراد أن يُفكك الجميع ويُركب من جديد
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم _الشيخ مجيد العقابي
حسن حنفي مفكرًا خاص، وزلزالًا في العقل العربي، رجلًا مزوّدًا بعدة التفكيك والتجديد، لم يكتفِ بمهاجمة الماضي، بل أعاد بناءه، ولم يهادن الحداثة، بل جابهها من الداخل، ولم يكن يسير في خط واحد، بل رسم لنفسه ثلاثة خطوط متوازية: نقد التراث، نقد الغرب، ونقد الذات. في مشروعه الأشهر “التراث والتجديد”، لم يكن الهدف إعادة شرح القديم بل إعادة صياغته كليًا، بجهاز مفاهيمي جديد، من النقل إلى العقل، من التقديس إلى التحليل، من سلطة الموروث إلى سلطان العقل. ولأنه كذلك، تفرّدت تجربته بين المفكرين العرب: فهو الذي قرأ الغرب في لغته، وقرأ الإسلام في عمقه، ثم سعى للمزاوجة بين الاثنين برؤية لا تخضع لا لمنطق التقليد، ولا لمنطق الإلغاء.
ولد حنفي عام 1935 وتخرّج من قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، ثم درس في السوربون، وهناك تشكّل وعيه النقدي حين واجه الاستشراق لا كمستمع أو قارئ، بل كموضوع مقاومة. عاد إلى مصر، وأطلق مشروعه الذي سيشغل أربعة عقود: إعادة بناء العلوم الإسلامية – علم الكلام، التصوف، التفسير – وفق رؤية معاصرة. كان يعتقد أن لا تقدم لأمة دون أن تُعيد تفسير تراثها، لا بهوس التجديد ولا بخضوع الاستهلاك، بل بمنهج فلسفي متماسك يُخرج النصوص من التجريد إلى الممارسة. مشروعه لم يكن تنويريًا بالمعنى الليبرالي، بل كان مشروع “تثوير معرفي” يتوسل أدوات الماركسية، والظاهراتية، والهيرمينوطيقا، ليعيد قراءة النص العربي الإسلامي من جديد.
في كتابه “التراث والتجديد”، كتب عبارته الشهيرة: “نحن لا نبدأ من الصفر بل من التراث، ولكن لا نقدّسه، بل نُدخله في التاريخ”، وهنا تتضح ملامح خطه الفلسفي: لا قطيعة مع الماضي، ولا اصطفاف مع الغرب، بل مسار ثالث يُخضِع الجميع للمساءلة. فالتجديد عنده ليس شعاراتيًّا، بل هو عمل طويل المدى، يبدأ من إعادة تشكيل الوعي، وينتهي بإعادة بناء المجتمع. في “من العقيدة إلى الثورة” أراد أن يُعيد بناء علم الكلام لا ليُثبت وجود الله، بل ليُحرّر الإنسان من سلطة الاستبداد باسم العقيدة. في “من الفناء إلى البقاء”، أعاد قراءة التصوف، لا بوصفه انسحابًا من العالم، بل كقوة روحية على التحرر. وفي “مقدمة في علم الاستغراب” نقل المواجهة من كوننا موضوعًا للدراسة إلى أن نُصبح ذاتًا دارسة، نُعرِّي الغرب كما عرّانا.
لكن حنفي لم يكتفِ بالتنظير، بل اشتبك مع الواقع. كتب في الصحافة، وخاض جدالات مفتوحة مع الأزهريين، والعلمانيين، والإسلاميين، حتى صار هدفًا مشتركًا لليمين واليسار، للديني والسياسي. الإسلاميون اتهموه بأنه يريد علمنة الإسلام، والعلمانيون اتهموه بأنه يريد أسلمة الحداثة، والمؤسسة الدينية خافت من منطقه، لأنه كان يُشبه الفقهاء في التأصيل، ويُخالفهم في المخرجات. حين كتب أن “الوحي علماني” بمعنى أنه لا يفصل الدين عن الحياة، وإنما يُدرجه فيها كمحرّك دنيوي وليس خطابًا غيبيًّا فقط، قامت عليه الدنيا. لكنه أوضح أن ما يقصده هو “أن الإسلام لا يحتاج إلى وسطاء ليُمارس”، بل هو دين الناس، لا دين الطبقة الفقهية وحدها.
ما يُحسب لحنفي أنه رفض منطق التبعية، سواء للتراث أو للغرب. فالاستشراق في نظره ليس علمًا بريئًا، بل هو معرفة مُسلحة، تُسهم في تكريس التبعية الثقافية. لذلك أسس علم “الاستغراب” كردّ فلسفي، لا انتقامي، على احتكار الغرب للمعرفة. فبدل أن نستهلك مفاهيمهم، علينا أن ننتج نحن مفاهيم عنهم، ونفهمهم من موقعنا. كما انتقد العلمانيين العرب الذين أرادوا إلغاء الدين لصالح حداثة غربية لا تنسجم مع البيئة العربية، واعتبر أن الحل ليس في محو الدين، بل في تأويله تأويلًا جديدًا يستجيب لمطالب العصر دون أن يخون أصالته. في رؤيته، الدين ليس خصمًا للحداثة، بل يمكن أن يكون حاملًا لها، شريطة أن نُعيد فهمه انطلاقًا من الإنسان لا من السلطة، ومن العقل لا من التكرار، ومن الحرية لا من الخوف.
وما يُؤخذ عليه، أن جرأته الفكرية ذهبت أحيانًا إلى حدود التفكيك دون تركيب واضح. فقد كان يُفكك العقيدة ويعيد بنائها، يُفكك النصوص ويعيد تأويلها، لكن من دون أن يُنتج مشروعًا تطبيقيًا واضحًا كما فعل غيره. كذلك، فإن اعتماده على الفلسفة الغربية – من هيغل إلى هوسرل – جعله أحيانًا يعبّر عن الإسلام بلغة غريبة عن بيئته الشعبية. ولذلك، بقي خطابه نخبويا، رغم محاولاته النزول إلى الصحافة والعمل العام. كما أن تحميله التراث كل مشاكل الحاضر، وإعادة تأويله وفق مفاهيم معاصرة (كالصراع الطبقي أو السلطة الرمزية)، جعله يبدو عند البعض وكأنه يُسقط العصر على النص لا يستنطقه من داخله.
مع ذلك، لا يمكن إنكار أثر حنفي العميق. فقد ساهم في تفجير أسئلة مسكوت عنها: هل يمكن تجديد الفقه؟ هل الوحي تاريخي أم فوق التاريخ؟ هل الغرب نموذج أم مرحلة؟ هل العلمانية نقيض الدين أم مقاربة له؟ لقد أعاد طرح هذه الأسئلة بمنهج فلسفي، لا انفعالي، وفتح أبوابًا للجدل لم تُغلق بعد. حتى الذين رفضوه، استعاروا لغته، وتأثروا بإلحاحه على إعادة بناء العلاقة بين الدين والعقل. وقد صار كتابه “التراث والتجديد” مرجعًا لا يمكن تجاوزه في أي حديث عن النهضة الفكرية في القرن العشرين، رغم أنه لم يصل يومًا إلى الجمهور العريض.
مات حسن حنفي عام 2021، دون أن ينال تكريمًا رسميًا يليق بمقامه، ودون أن يُفهَم تمامًا. رحل وهو يشعر أن مشروعه لا يزال في بدايته، وأن الأمة لم تبدأ بعد المعركة الحقيقية مع وعيها. لم يُعطه الإعلام ما يستحق، ولم يُترجم مشروعه كاملاً، ومع ذلك بقي في ذاكرة الباحثين كصوت مزعج للمسلّمات، وصاحب مشروع لم يُغلق، ومفكر صاغ “أصعب معادلة”: أن تبقى مسلمًا، وتكون حداثيًا، دون أن تخون الاثنين.
الشيخ مجيد العقابي
مركز الفكر للحوار والإصلاح
27-05-2025