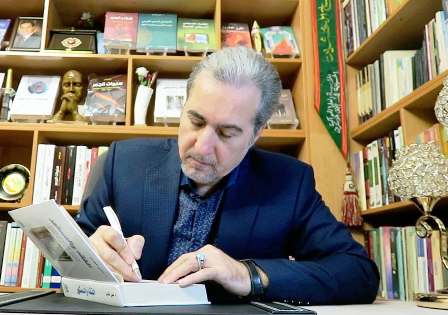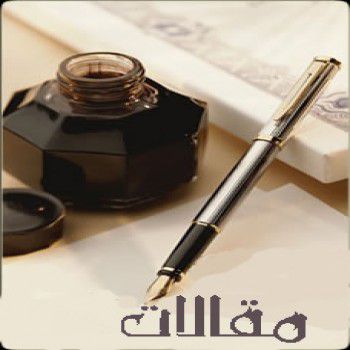مشيخة الدولة العباسية بين الصادق ومالك وأبي حنيفة..!
بقلم _ د. علي المؤمن
كانت بداية اهتمام الدولة العباسية بتقريب الفقهاء السنة إليها وخلق طبقة من فقهاء السلطة، لاستغلالهم في مواجهة أئمة آل البيت والتشيع، مع محاولات الخلفية العباسي الأول أبو العباس السفاح مع الفقيه ربيعة الرأي التميمي (ت 136 ه)، حين طلب منه أن يكون قاضي الدولة العباسية، كما أرسل له خمسة آلاف درهم ليشتري بها جارية؛ فامتنع الشيخ ربيعة عن قبول المنصب والجائزة، رفضاً للتعاون مع السلطة، رغم كونه أبرز الفقهاء السنة في المدينة، وأستاذ الإمام مالك بن أنس، ما أدى إلى أُفول نجم ربيعة واندثار مذهبه، ثم بروز مذهب تلميذه مالك الأقل علماً منه، بسبب ارتباطه بالسلطة، برغم وجود فقهاء سنة كبار، يشهد لهم الفقهاء الآخرون بأنهم أعلم وأكثر تقوى من الإمام مالك، كربيعة والليث وأبي حنيفة وسفيان الثوري.
وكان ربيعة يقول: «أما علمتم أن مثقالاً من دولة، خيرٌ من حِمل علم»، وهي كناية لغلبة أهمية المرتبط بالسلطة على الأعلم، في إشارة واضحة الى الفارق بين وضعه ووضع تلميذه مالك.
أما المنصور الدوانيقي؛ فقد استغل تعارضات الفقهاء الشخصية والعلمية، ليلعب على تناقضين، التناقض القومي والتناقض الطائفي؛ فقد كان في بداية حكمه يدعم أبا حنيفة، بهدف ضرب كبرياء العرب وفقهاء المدينة، لكون أبو حنيفة فارسياً، ولأن العباسيين اعتمدوا أساساً على العنصر الفارسي في التأسيس لدولتهم، وهو ما كان يُسخط عرب الحجاز. وكان المنصور يقابلهم بالتصعيد.
ولكن؛ حين فشل المنصور في استقطاب الإمام أبي حنيفة، كما فشل من قبله السفاح في استقطاب ربيعة الرأي؛ فإنه اتجه الى المحاولة مع الإمام مالك بن أنس؛ فنجح في مسعاه، وصولاً الى تثبيت مذهب مالك بن انس مذهباً رسمياً للدولة، وحصر الإفتاء به، نكاية بمذهب آل البيت الذي كان يتزعمه آنذاك الإمام الصادق، وهو بمثابة أستاذ الإمام مالك والإمام أبي حنيفة.
ودليل هذه النكاية قول المنصور للإمام مالك: «ضع للناس كتاباً أحملهم عليه… فما أحدٌ اليوم أعلمُ منك». وقول آخر له يطمئن فيه مالكاً: «لئن بقيتُ، لأكتبنّ قولك كما تُكتب المصاحف، ولأبعثنّ به إلى الآفاق فأحملهم عليه)).
فقال له مالك: «إنّ أهل العراق لا يرضون عِلْمَنَا»، فقال المنصور: «أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفاً ولا عدلاً؛ فالعلمُ علمُ أهل المدينة».
وأضاف يبشر مالكاً بأنه سيفرض فقهه بالسيف على أهل العراق بقوله: «أضرب عليه هامتهم بالسيف، وأقطع عليه ظهورهم بالسياط». وهذا دليل آخر على حقد المنصور المتراكم على أهل العراق، بسبب تشيعهم لآل البيت، وهو ما ينسجم مع موقف مالك الذي يعلم إن أهل العراق متشيعون ويرفضونه.
ويمكن تلخيص أسباب اختيار المنصور لمالك، في ثلاثة:
1- موقف مالك السلبي من الإمام علي؛ إذ كان يساويه بعامة الناس، وحتى ليس بمستوى الخلفاء الثلاث وقدرهم، وعندما كان يُسأل عن سبب ذلك يقول: ((ليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه»، وفيه تعريض بالإمام علي بأنه كان يطلب الخلافة، بينما لم يطلبها الخلفاء الثلاثة.
ويصف بعض العلماء السنة بأن هذا الرأي ((يدلّ على نزعة أموية)) لدى مالك. وكان هذا الرأي يمثل حاجة سياسية ملحة للمنصور وللخلفاء الذين جاءوا من بعده: المهدي والهادي وهارون الرشيد،
ليكون ركيزة عقدية في مواجهة العلويين وشيعة العراق وثوراتهم، وخاصة بعد ثورة السيد محمد النفس الزكية الحسني (ت 145 ه). وذلك على العكس من فقهاء العراق السنة الآخرين، الذين كانوا يتعاطفون مع العلويين والشيعة، وفي مقدمهم الإمام أبي حنيفة، الذي وقف موقفاً مناصراً للعلويين، وخاصة لثورة زيد بن علي (ت 132) ثم ثورة محمد النفس الزكية.
وكان الإمام مالك بن أنس، قبل التحاقه بالسلطة العباسية، قد أفتى بجواز الخروج مع محمد النفس الزكية، فقيل له: ((إن في أعناقنا بيعة للمنصور))؛ فقال: ((إنما كنتم مكرهين، وليس لمكرَه بيعة)). وكان ذلك سبباً في تعرض مالك الى الضرب من والي المدينة، وأعقبه اعتذار المنصور له، وتقريبه إليه، وانعقاد الحلف بين الطرفين.
2- إعراب الإمام مالك عن استعداده للعمل وظيفياً في إطار الدولة العباسية، وشرعنة عمل الدولة وسلوكياتها، في مواجهة المعارضة، وخاصة المعارضة الشيعية. وفي المقابل، يتيح له المنصور نشر مذهبه، وتحويله الى مذهب رسمي للدولة. وقد تم له ذلك بالفعل خلال خلافة المنصور والمهدي والهادي والرشيد، فكان بمثابة مفتي البلاط.
3- فتاوى مالك بن أنس بحرمة الخروج على الحاكم الظالم، ووجوب اعتزال الحراكات الثورية.
وبالتزامن مع فرض المنصور تقليد الفقهاء السنة على عامة المسلمين؛ فإن موقفه من الإمام جعفر الصادق كان موقفاً معادياً، بالرغم من عدم قيام الإمام الصادق بأي حراك سياسي علني مناوئ للسلطة، وعدم دعمه الظاهري للحراك الثوري الشيعي الذي قام بها عمه السيد زيد بن الإمام السجاد، أو ثورات أولاد عمه الحسنيين، ورفضه ــ فيما سبق ــ منصب الخلافة الذي عرضه عليه القائد الشيعي أبو مسلم الخراساني، وكذلك أبو سلمة الخلال.
ولم يكن رفض الإمام الصادق للخلافة زهداً بها أو عدم إيمانه بأنها حقه، لكنه يعلم أن دعوات العباسيين لآل البيت وتوجهات أبو مسلم وأبو سلمة، إنما هي ألاعيب سياسية وأطماع يُراد بها توريط الإمام الصادق، ولا تنطلق من إيمان هؤلاء بحق آل البيت، وهو ما يتضح من جواب الإمام الصادق لأبي مسلم الخراساني، ورفضه التقرب من البلاط العباسي، رغم أنهم أبناء عمومته.
وبلغ عداء المنصور الدوانيقي للإمام الصادق ذروته عندما أحرق داره؛ إذ أوعز الى واليه في المدينة بذلك؛ فجاءوا بالحطب الجزل ووضعوه على باب دار الإمام الصادق، وأضرموا فيه النار. وحينما أخذت النار ما في الدهليز، تصايحنَ النساء من عائلة الإمام داخل الدار وارتفعت أصواتهن؛ فخرج الإمام الصادق، وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، وجعل يخمد النار ويطفئ الحريق، حتى قضى عليها، وهو يقول: ((أنا ابن أعراق الثرى أنا ابن إبراهيم خليل الله عليه السلام)). وانتهى الأمر إلى مقتل الإمام الصادق على يد المنصور.
وسار الخلفاء الثلاثة الذين أعقبوا المنصور: المهدي والهادي وهارون الرشيد، على خطى سلفهم، حتى يذكر المؤرخون ((أن هارون الرشيد أراد أن يعلّق الموطّأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه)). ولما أراد الرشيد العودة إلى العراق منطلقاً من المدينة، قال لمالك: «ينبغي أن تخرج معي، فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطّأ كما حمل عثمان الناس على القرآن»، ثم أخذ منادو الرشيد في بغداد والولايات الإسلامية، ينادون: «لا يفتي إلا مالك».
ورغم كل هذا التطرف في فرض مذهب مالك؛ إلّا أن هارون الرشيد فشل في فرضه في العراق، لشدة كراهية العراقيين لمذهبه، بسبب ميولهم للتشيع، ولكونهم يرون في مالك نزعة أموية، كما مر، لذلك؛ اقتنع الرشيد بعد وفاة أبي حنيفة باستمالة أبرز تلاميذه في العراق، وهو الشيخ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، المعروف بأبي يوسف القاضي، الذي بات قريباً جداً من الرشيد،
حتى قال الرشيد لأبي يوسف: «لو جاز لي إدخالك في نسبي ومشاركتك في الخلافة المفضيّة إليَّ لكنت حقيقاً به»، وهو ما سمح لأبي يوسف القاضي العمل بكل قوة على نشر المذهب، وأصبحت تولية رجال القضاء في العراق وخراسان والشام ومصر بإشارة منه، حتى أعلن هارون الرشيد المذهب الحنفي مذهباً رسمياً للدولة.
وإضافة الى أبي يوسف القاضي؛ فقد عمل ثلاثة تلاميذ آخرين للإمام أبي حنيفة، هم: محمد بن الحسن الشيباني، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وآخرون جاؤوا من بعدهم، على نشر المذهب الحنفي في جميع مفاصل الدولة العباسية، وكان لهم الدور التاريخي الأهم في صياغة شكل المذهب الحنفي وفقهه واجتماعه الديني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة “كتابات علي المؤمن” الجديدة وارشيف مقالاته ومؤلفاته بنسخة (Pdf) على تلغرام: https://t.me/alialmomen64